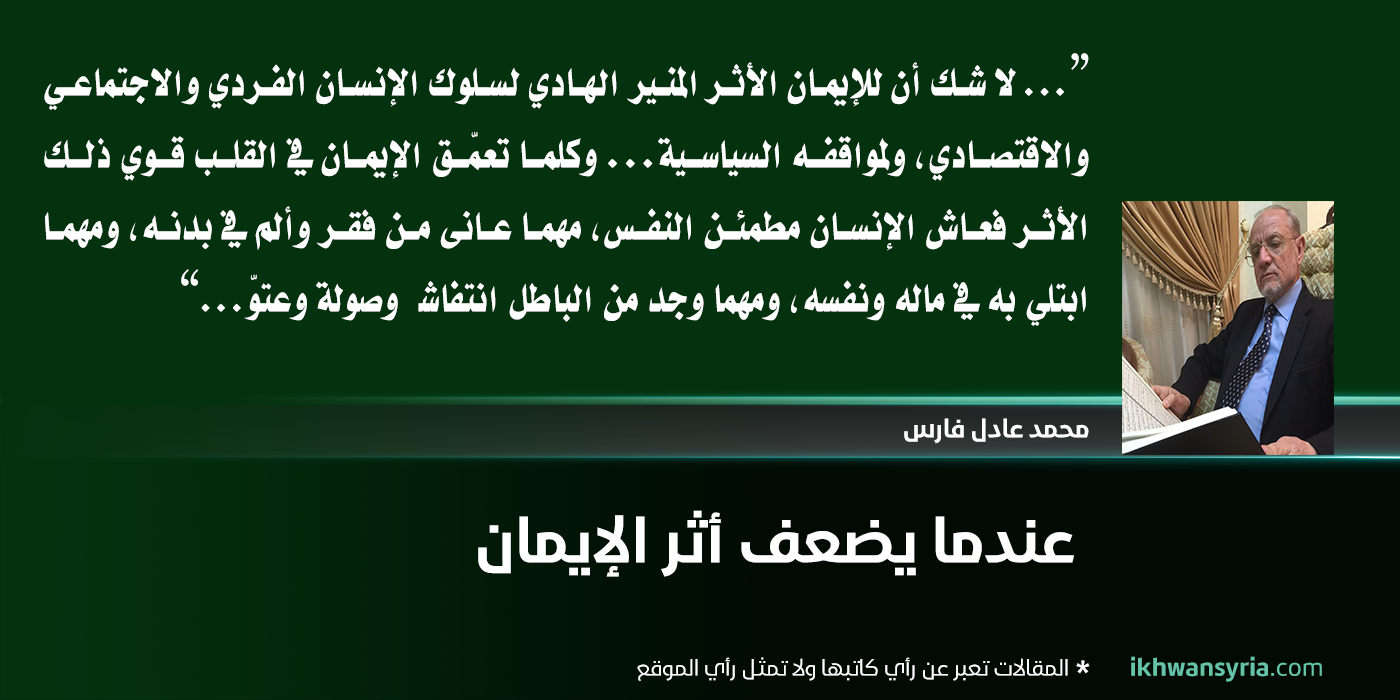لماذا يؤكد القرآن الكريم قيمة الإيمان، ويَقْسم الناس إلى مؤمنين وكافرين، ويربط سعادة الإنسان، في دنياه وآخرته، بإيمانه، كما يربط شقاوته بكفره؟!.
لا شك أن للإيمان الأثر المنير الهادي لسلوك الإنسان الفردي والاجتماعي والاقتصادي، ولمواقفه السياسية… وكلما تعمّق الإيمان في القلب قوي ذلك الأثر فعاش الإنسان مطمئن النفس، مهما عانى من فقر وألم في بدنه، ومهما ابتلي به في ماله ونفسه، ومهما وجد من الباطل انتفاشاً وصولة وعتوّاً.
وكذلك فكلما ضعف الإيمان في القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح تقصيراً في القيام بما أمر الله به، ووقوعاً فيما نهى عنه، وشعوراً بالخزي والانبهار أمام الجاهلية وأربابها، فلا عجب عندئذ، ممن ضعف إيمانه، أن يتوانى عن نصرة الدين، وأن يختار الطريق الذي يرجو فيه السلامة في أمور دنياه، وإن كان يؤدي إلى خسران آخرته، بل يؤدي كذلك إلى عيش ذليل في هذه الدنيا.
الإيمان باللّه واليوم الآخر هو الذي يجعل المؤمن يقوم راضياً بتكاليف تُضادّ شهوته من حب الرئاسة وحب المال وحب الشهرة وحب الراحة…
والإيمان هو الذي يصحّح تصوّر الإنسان عن نفسه وعن الكون من حوله… فيرى أنه جزء من هذا الكون الصديق المخلوق لله، الطائع لله… ويعلم أنه لا يخرج عن الامتثال لمنهج الله إلا الذين كفروا. ((ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يَغرُرْك تقلّبهم في البلاد)). {سورة غافر: 4}.
فهؤلاء الذين كفروا، حتى لو ملؤوا الأرض كلها، هم شرذمة قليلون شاذّون عن الكون المسبّح لله، وهم إلى دمار وهلاك، إلا أنْ يتدبروا أمرهم ويفيئوا إلى توحيد الله وعبادته. والمؤمن لا ينظر إليهم بإعجاب وانبهار، بل قصارى ما يتمناه لهم إنما هي الهداية إلى الحق والصواب.
والإيمان باللّه يجعل المؤمن منسجماً مع المخلوقات: ((أفغير دين الله يبغون وله أسلم مَن في السماوات والأرض)). {سورة آل عمران: 83}، كما يجعله مطمئناً إلى أن هذا الدين، بعقيدته وأحكامه وأخلاقه، هو الذي يمثل القانون الذي اختاره الله للكون وللإنسان: ((فأقم وجهك للدين حنيفاً. فطرة الله التي فطر الناس عليها)). {سورة الروم: 30}.
والإيمان يُشيع في النفس الأمل، فاللّه سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت بيده الملك وهو على كل شيء قدير… فهو سبحانه مع عباده، يحفظهم ويكلؤهم ويجعل أمرهم كله إلى خير… والمؤمن يطيع أحكام الله واثقاً بأنها هي الحق، وإذا أخفق في عمل أو نزلت به مصيبة فهذا من قدر الله، ومن ثَمّ يراجع المؤمن نفسه لعله يتدارك ما صدر عنه من خطأ أو تقصير أو انحراف.
وأما من حُرِم الإيمان فيعيش في غفلة وغرور وتخبط، فسرعان ما يَدخل اليأس إلى قلبه لدى أي إخفاق، وتسودّ الحياة في عينيه، وقد ينهي حياته بالانتحار…
والإيمان يجعل المؤمن واثقاً بمعية الله ونصره وعدله وفضله: ((إن تنصروا الله ينصركم)). {سورة محمد: 7}، و((إن الله لا يضيع أجر المحسنين)). {سورة يوسف: 90}. وهذا ما يسكب الطمأنينة في النفس، ويملؤها بالأمل والرضا، ويدفعها إلى البذل والعطاء والإيثار… فلا يضيع عند الله مثقال ذرة من خير، ولا يتخلّف اليسر عن العسر، والمؤمن دائماً إلى خير: “إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيراً له”. رواه مسلم.
فما أعظمه من أمر أن يعمل المربون والموجهون والخطباء… على تعميق الإيمان في القلوب، فتمتلئ حبّاً لله، وخشية منه، ورجاء رحمته، وخوف عذابه، وابتغاء رضوانه، وتوكلاً عليه، ولجوءاً إليه…
وما أعظمها جريمة أن تتلاشى هذه المعاني، ولو تدريجياً، من المناهج المدرسية والأنشطة الثقافية والإعلامية! فتنشأ أجيال تتغذّى بقيم ومفاهيم، منها الصحيح ومنها الزائف، ولكنها جميعاً لا تكون لها جذور في قلوب الناس وفطرتهم، فسرعان ما يتخلون عنها كلما تعارضت مع شهواتهم.
ورحم الله عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، لما قال: “لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلمُ حلالها وحرامها…”. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علّة. ووافقه الذهبي.