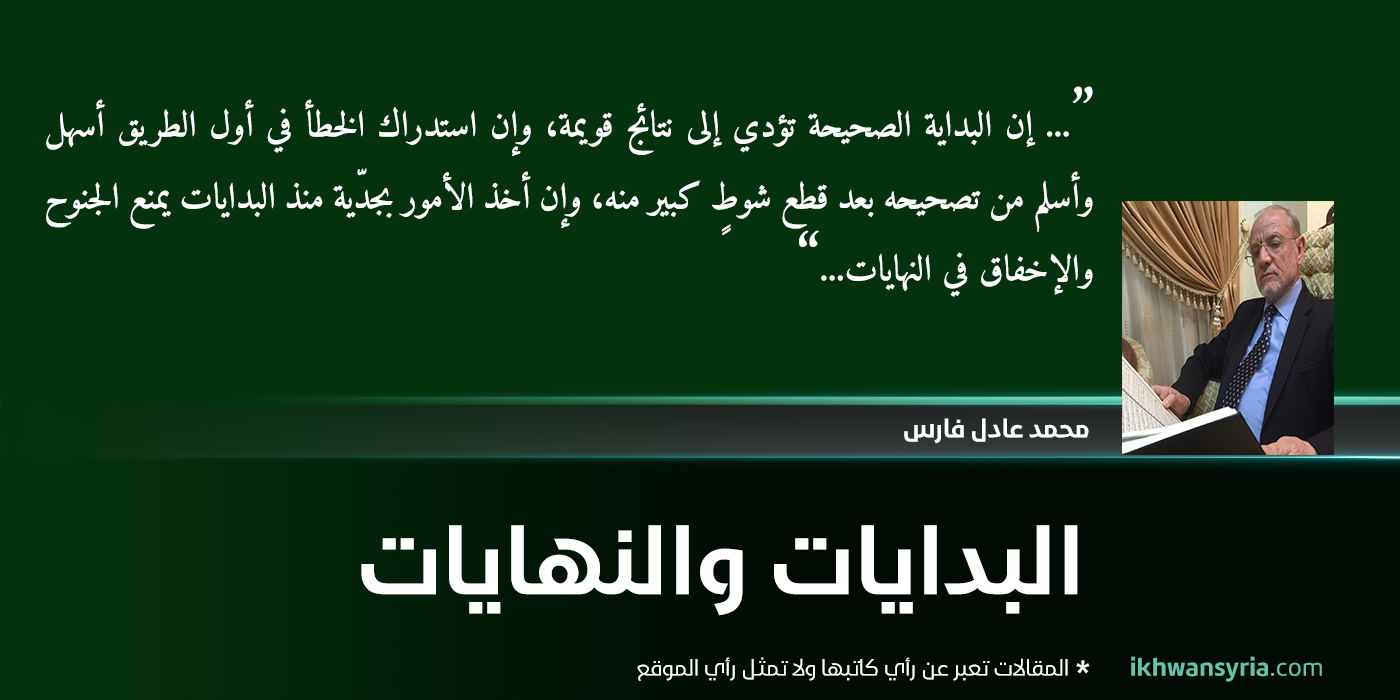يبدو أن الحديث عن الربط بين بدايات الأمور ونهاياتها أمر شائق، فنجده ظاهراً في مؤلفات تحمل هذا الاسم أو ما يقاربه، كالبداية والنهاية (في التاريخ) للإمام ابن كثير، وبداية ونهاية (قصة) لنجيب محفوظ. أو نجده في أقوال وأمثال تؤكد هذا الربط، كما تقول القاعدة الأصولية: “يقال في النهايات ما لا يقال في البدايات” بمعنى أن الأمر إذا استقر وأصبح أمراً واقعاً، يُتعامل معه على غير الصورة التي يُتعامل معه وهو في طور الإنشاء. وكقول أرباب رياضات النفوس: “من لم تكن له بداية مُحْرِقة، لم تكن له نهاية مشرقة” بمعنى أن من لم يجِدّ كل الجِدّ في بداية أمره، لا يُنتظر له مستقبل زاهر.
وفي ارتباط النهاية بالبداية يتناقل المربّون قول الشاعر:
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوَّده أبوه
فما ابتدأت به حياة الإنسان في ظل والديه يكون ذا أثر يُظلّل شخصيته طوال حياته. وهو المعنى ذاته الذي يؤكده علماء النفس التربوي حين يقولون: إن شخصية الإنسان تتبلور في السنوات الخمس الأولى من عمره، وتكون الجهود التربوية التي تُبذل معه بعدئذ معدّلة ومطوّرة في الشخصية، أما السمات الكبيرة فقد ترسخت منذ الصغر.
وقريب من المعاني التي نتناولها نجده في قولهم: “العلم في الصغر كالنقش في الحجر” وقول البوصيري:
والنفسُ كالطفل إن تُهملْه شبّ على حب الرضاع وإن تَفْطمه ينفطم
وحتى لا نبقى في الأدبيات والعموميات، نأخذ مثالين من واقع الحياة لتُقاس عليهما أمثلة شتى:
الأول: التقيت صديقاً لي، كانت مشاغل الحياة وظروفها قد حالت بيني وبينه بضع سنين، كان أولاده، يوم كنا قريبين، أطفالاً صغاراً، طالما حملتُهم بين يديّ، ولاعبتُهم… والآن قد ناهز بعضهم الحُلُم…
حين سألته عن ابنه الأكبر، زفر زفرة طويلة ثم قال: ماذا أقول لك عن هذا الشقي؟! قلتُ: ماذا في الأمر؟! إنني أعرفه طفلاً ذكياً مهذباً نشيطاً. وقد كان آخر عهدي به تلميذاً في الصف السادس الابتدائي.
قال صديقي: هذا الولد هو مصدر شقائي وشقاء الأسرة كلها، بل هو مصدر الإفساد لإخوته الأصغر منه. فهو لا يسمع ولا يُطيع، بل يشاكس ويعاند. لو قلت أمامه: إن اللبن أبيض، لكان هذا دافعاً له ليقول: بل هو أحمر؟!
قلت: ومتى تحوّل إلى هذه الحال، وكنت أعرفه طفلاً مثالياً، أو قريباً من المثالي؟!
قال لي: إنها قصة طويلة. على كل حال حبّذا لو زُرتنا، وجلستَ معه. إنه لا شك يُحِسّ تجاهك بالمودّة والاحترام، ولعله يتقبّل منك النصح والتوجيه.
ضربت موعداً لزيارة صديقي، لأجدد معرفتي بأولاده الذين أعدّهم مثل أولادي في المحبة والمكانة.
في أثناء زيارتي شاهدت صورة أخرى:
طفله الصغير الذي لا يتجاوز السنوات الثلاث من عمره، كان إذا طلب طعاماً، أو لعبة… هبّ جميع أفراد الأسرة لتلبية طلبه، وإذا تأخروا أو امتنعوا قَلَبَ الدنيا على رؤوسهم، وارتفع صراخه وبكاؤه… وهذا يضطرهم للاستجابة له. فإذا نال ما يريد ضَحِكَ وانبسطت أساريره، وعاد إلى لعِبه، واستقبل الابتسامات وكلمات التودد من الكبار والصغار.
قلت لصديقي: لم هذا الدلال كله؟! لِمَ تستجيبون له كل هذه الاستجابة؟! لماذا لا تزجرونه إذا أساء؟!… قال: يا أستاذ، إنه، كما ترى، ما يزال صغيراً فهو لا يفهم بعد، وليس من المناسب أن نحاسبه محاسبة الكبار، وأن نعامله وكأنه بالغ راشد.
قلتُ: ما رأيك بابنك البالغ الراشد الذي شكوته لي بالأمس؟! لماذا لا تزجره وتقوّمه؟! قال: الأمر يختلف. إنه قد شبّ عن الطوق، واستعصى على الانقياد.
قلت: أنا لم أقل: عاملِ الطفل معاملة الكبار، وحاسِبْه محاسبة البالغين. ولكن لابد أن يجد عبوساً وازوراراً من الكبار حين يخطئ، ولابد أن يعْلم أن طلباته الكثيرة ليست أوامر واجبة التنفيذ، وأن الكبار ليسوا عبيداً عنده أو خدماً. بل هو واحد من أفراد البيت، يلقى الدلال في أكثر الأحيان، ويلقى الاستحسان ممن حوله إذا تصرف تصرفاً حسناً، كما يلقى الزجر إذا أساء، ويلقى الإهمال أو الحرمان إذا تعنّتَ في الطلب…
إن هذه البداية التي يلقاها الآن في تربيته تُعطيه تصوّراً عن نفسه أنه قُطب الرّحى وأنه أعلى شأناً من كل من حوله، وأن الآخرين بمقام الخدم له، يأمرهم فيطيعون… فإذا كبر صعب عليه أن يتقبل صورة أخرى غير التي كان قد نشأ عليها.
ولعل هذه نفسها مشكلتك مع ابنك الكبير: حين كان صغيراً كنت تلبي له كل طلب، ولا تقوّم سلوكه أو تزجره حين يخطئ، بحجة أنه صغير لا يدرك… فلما كبر استعصى على التقويم والنصح.
هل أذكّرك بقول الله تعالى: ((يأيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً…)) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع…” بل أحب أن أذكر لك حديثاً قلّ من ينتبه إلى أهميته ودلالته.
ففي حديث – رواه الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما – أن الحسن بن علي – وكان طفلاً في حِجْر النبي صلى الله عليه وسلم – أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كِخْ كِخ، ليطرحها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة؟.
مثل هذه التربية، في هذه السن المبكرة، جعلت الحسن بن علي سيّد شباب أهل الجنة…
الثاني: اعتياد التدخين، أو الإدمان عليه…
معظم الذين يُبتلَون بالتدخين يبدؤون المأساة في بداية مرحلة البلوغ (أو قُبيلها أو بُعيدها). يُحسّون في هذه المرحلة بدافع إلى ممارسة هذه العادة ليُشبعوا عندهم الشعور بالرجولة!! أو ليتذوقوا ما يحسبونه لذّة يستأثر بها الكبار، أو ليُجاروا عادة يجدونها في أقرانهم، فيحققوا الشعور بالانتماء إلى مجموعة الأقران…
وهم في هذه المرحلة يجهلون، أو يتجاهلون، مضار التدخين.
وبعد فترة، قد تبلغ سنة، أو تمتد إلى سنوات، يحسون بأضرار التدخين ولا يستطيعون تجاهلها. لكن تعلّقهم بها، الذي يصل إلى درجة الإدمان، يجعل تخلّصهم منه أمراً صعباً.
في البداية لم يكترثوا بالخطر، وفي النهاية يضعُفون عن الخروج منه.
إن البداية الصحيحة تؤدي إلى نتائج قويمة، وإن استدراك الخطأ في أول الطريق أسهل وأسلم من تصحيحه بعد قطع شوطٍ كبير منه، وإن أخذ الأمور بجدّية منذ البدايات يمنع الجنوح والإخفاق في النهايات…
وإنها لموعظة لكل من يبغي السلامة، فالإنسان يكاد يواجه كل يوم بداية لأمر من الأمور، فليأخذه بجدٍّ إذا رآه حسناً، ولْيتجنّبْه بحزمٍ إذا رآه قبيحاً. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان عبرة لمن يعتبر!.
بل نستطيع أن ندرك أثر البدايات وخطورة النهايات في كثير من الظواهر الدينية والاجتماعية والسياسية… فحين تنبُتُ نابتةُ السوء في المجتمع، يقوم بعض الأخيار بالتحذير منها والمبادرة إلى علاجها، فيعترضهم آخرون ليقولوا: إنكم تتوهّمون! هذا الذي تحذرون منه لا يعدو أن يكون أحداثاً فردية تافهة، وما عليكم إلا أن تهملوها فتندثر. فإذا قال لهم الأولون: بل هي بدايات خطيرة لها ما بعدها، وقد أصابت عدداً لافتاً للانتباه من أبناء المجتمع أو من مؤسساته. أجاب الآخرون: بل أنتم تبالغون. إنها لا تعدو أن تكون حالات شاذّة نادرة.
وتمضي الأيام والشهور وتغدو نابتة السوء ظاهرة لا تخطئها العين، يصك السمعَ أزيزُها، وتزكُم الأنوفَ رائحتها، فيقوم الخيرون ينادون: أنقذوا المجتمع من هذا الخطر فيردُّ الأولون: وهل لنا طاقة بمقاومة الخطر الذي استفحل وعمَّ وطمَّ؟! ليس لنا إلا أن نتعايش معه!.
لقد تساهلوا بالأمر في بدايته، بل تعامَوا عنه، وأعلنوا عجزهم عن علاجه بعد ما استفحل. ولو أنهم رُزقوا النظر السديد والهمة العالية فسارعوا إلى إطفاء النار يوم كانت شعلة ضئيلة، لسهل عليهم ذلك، ولما تحوّل إلى حريق يأكل الأخضر واليابس!.