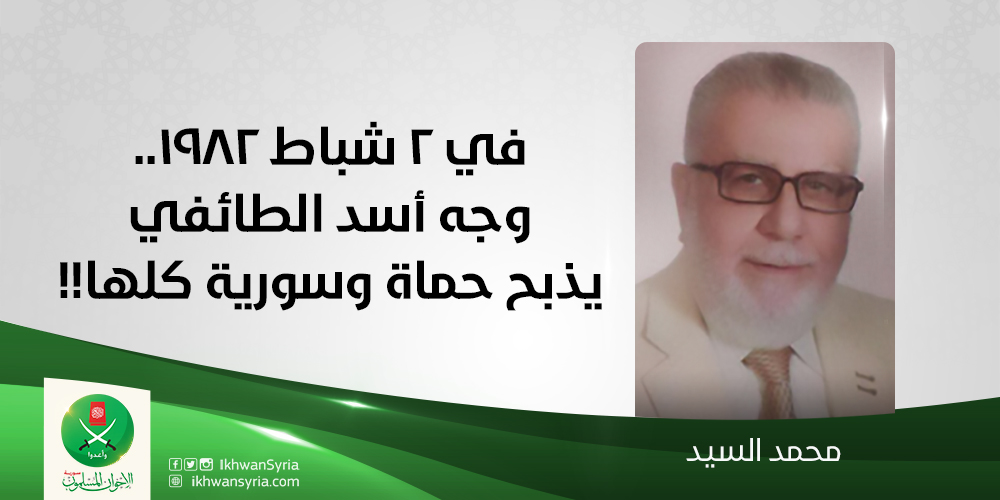محمد السيد
1- مقدمة
هذا هو شباط… يعود بالذكرى، ذكرى حماة الحاضرة في عيوننا وقلوبنا، بمساجدها وتاريخها وحاضرها ومغانيها ومجاهديها شيباً وشباباً رجالاً ونساءً وسيرة أبنائها الأباة، الذين لم يهادنوا الضيم يوماً من الأيام، ولم يتوانوا عن نصرة الحق والدين لحظة من اللحظات.
إنها الذكرى التاسعة والثلاثون لمأساة مدينة أبي الفداء (صاحب صلاح الدين) الصابرة المصابرة، التي ما يزال أبناؤها وأبناء سورية كلها يرابطون على حافة الجراح، التي نكأتها الأيدي الهمجية في 2 شباط عام 1982 بعد أن ملأت أنحاء سورية بشتى أنواع المجازر والآلام، ارتكبت فظائعها عائلة أسد المارقة.
ذات يوم ولما تغادر خطوات شباط عام 1982 عتبات الزمن بعد، أطل الغادرون على حواري حماة بنيران الحقد والطغيان، فاكفهر وجه الأيام، وتقارب الزمن، فانفتحت الخنادق في موقع سريحين لتتلقى الأجساد الطاهرة، التي عاجلتها أيدٍ عبثت بعقول أصحابها أوكار اللعب العالمي، فزينت لهم قتل الأوطان وأبناء الأوطان، كما سهّلت لهم ابتلاع الهوان، وزخرفت في عيونهم فتح جروح الأجيال والتلاعب بحقائق التاريخ والجغرافيا والحاضر المزدحم بشتى الأخطار، ثم تعميم الدمار على يدي باطنية أسد وزبانيته على كل الجغرافيا السورية.
حماة مدينة عظيمة عظم التاريخ، ترقد متبرجة على ضفاف العاصي الخالد، متغنية ببضع أبيات تتساوق مع لحن الناعورة المتفائلة، تعاجلها يد مضرجة بأوامر الأعداء، لتمتلئ الأرجاء بدخان الغدر والوقيعة، فتشتعل الأحياء بالفتنة، وترتدي النهاية رماداً يستر جمراً يقول: إن لم يعتذر الطغيان عن مُرّ الفجيعة بعدالة الحساب، فلن تصفو القلوب المكلومة لمن حاول إطفاء شعلتها.. ذات يوم، ولن يكون نسيان!!
وتململ مني التفكر بما جرى للمدينة المقدامة بسؤال: هل ما جرى لها كان فجأة أم أن العصابة المارقة الرافضية الأسدية، استبقت الانقضاض عليها بحقد طائفي دفين؛ صنعوا منه رعباً شنيعاً على مدى خمسة عقود من القرن العشرين والواحد والعشرين، ليكون ذلك الهدم لمدينة حماة بتاريخها وحاضرها دليلاً للوريث المعتوه ابن حافظ العميل الصهيوأمريكي المأفون.
نعم.. إنه التحضير المدعوم من الأعداء كافة، وإذاً، فإن مأساة حماة في هذا العصر ما تزال تتكرر بإرهاب أعظم في عهد الوريث المعتوه بشار الذي تهيئه روسيا بدعم غربي لولاية رئاسية ثالثة بهدف إكمال مهمة الذبح والهدم والتغيير الديموغرافي. وإليك قارئي الكريم الإرهاصات التي أوصلت البلاد إلى مأساه العصر التي من المهم ذكرها للتعرف على الفجائع التي أوصلت إلى فجيعة حماة الكبرى.
2- الإرهاصات
بعد أن خرجت مصر من المعركة مع الصهاينة على يد السادات في أواخر السبعينات من هذا القرن، أصبحت سورية تمثل أكبر وأقوى دول المواجهة مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، بحدود مع العدو يبلغ طولها ثمانين كيلومتراً.
لذا فإن هذه المكانة لسورية والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز، يفرضان على كل من يتصدى للحكم فيها -إن كان مخلصاً لوطنه وأمته وقضيتها- أموراً خطيرة أهمها: المحافظة على الوحدة الوطنية داخل البلد متماسكة قوية متينة الأسس، متمثلة بجيش قوي متجانس، موحد الأهداف، محافظ على دين الأمة وترابها، وأن يكون شعبها قوياً مشاركاً فعالاً، يمتلك زمام حريته ووسائل النقد المناسبة، كما يمتلك اقتصاداً متيناً متطوراً، مبنياً على إمكانات البلد الممتازة، ومهارة الشعب السوري المعروفة.
فإذا تناسى أي حاكم هذه الأمور، وغاص في الفئوية، وانشغل بنفسه وكرسيّه، وكرّس كلّ همّه في المحافظة عليه، والتهيئة لانتقال السلطة في عقبه، فضرب يميناً وشمالاً، وفرّق وقسّم، وقرّب وبعّد، وقمع وحاصر، وصرف الأوقات والأموال والجهود والثروات من أجل جمع الموالين والمصفقين، وإبعاد بل وقمع بل وقتل المعارضين وتفريق شملهم، إذا فعل الحاكم ذلك فقد أبحر بعيداً في خضم إضعاف الجبهة السورية، وتلاشي قواها، وانهيار جدران مقاومتها، ثم أخيراً حاز عداء الشعب وقواه المتنوعة، وألّب الفئات الحية فيه، وجرّها إلى ساحات المواجهة، دون رغبة منها أو تخطيط أو استقبال. وذلك كله خدمة للصهاينة في تهديم القوة السورية، والخلاص من أية مقاومة.
إن الذي حدث في سورية، منذ انقلاب آذار 1963، هو شيء من هذا القبيل:
فقد بدأ موجهو الانقلاب باستبعاد فئات الشعب وأحزابه، وحصر السلطة والحياة السياسية والاجتماعية بحزب البعث، كمؤسسة وحيدة، يحق لها الحركة والعمل داخل الشعب السوري، وأصبح من لم ينتم إلى هذا الحزب خارج القوس، وهو متهم ومهمل ومهمّش، أو معتقل ومشبوه وملاحق، أو مراقب محروم من العمل أو الوظيفة والحرية والحركة.
ولقد أشار إلى هذه الحالة الأستاذ ميشيل عفلق منذ تموز عام 1963، في بيان له أمام القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث، مبيناً خطورة تعاظم الدور الطائفي في السيطرة على الحزب، وموضحاً خطورة ما يجري من سيطرة الجناح العسكري على الجناح المدني السياسي في الحزب أيضاً، وشارحاً خطورة حصر العمل السياسي في الحزب، حيث أدى ذلك إلى كثرة الانتهازيين في صفوفه، وهو ما دعا الانتهازيين والمغامرين العسكريين والطائفيين إلى القيام بانقلاب 23 شباط 1966 بقياده صلاح جديد (1). وهكذا أصبح الحزب بعد ذلك بؤرة واجهية للطائفية والاحتكار الحركي والعمل السياسي المبني على قمع كل من له رأي لا يناسب الفئة الحاكمة، وبقي الوضع شراكة بين صلاح جديد وحافظ الأسد منذ شباط 1966 وحتى 16 تشرين الثاني 1970، قام حافظ الأسد بانقلاب انفرد فيه بالحكم وأقام نظاماً في البلاد، عرّض فيه الشعب إلى كل أنواع المحن، تحت سمع وبصر الدستور الذي وضعه بنفسه عام 1973، إذ جاء في ذلك الدستور من المواد التي نذكر منها:
المادة 131 التي تنص على استقلال القضاء فتقول:
“السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الاعلى”.
والمادة 133 تنص على أن: “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”.
وتنص المادة -38- على أن: “لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلانية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء.. وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون”.
وتقول المادة 39: “للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحق”.
وتنص المادة (3/28) على أنه: ” لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك”.
ورغم كل هذه النصوص، فقد أخضع الانقلاب البلاد منذ عام 1970 وحتى اللحظة لقوانين الطوارئ، وأهملت كل حقوق المواطن، وأهدرت كرامته وحريته. وقد شهدت تقارير منظمة العفو الدولية المتتالية لهذا الأمر، وقد ذكر في تقرير عام 1995 ما يلي: “ما يزال الآلاف يتعرضون لشتى ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، ومن بينها القبض التعسفي، والمحاكمات الجائرة، والاعتقال إلى أجل غير مسمى، من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب، والوفاة تحت وطأه التعذيب، والاختفاء، والإعدام. وقد لفتت منظمة العفو الدولية أنظار السلطات السورية مراراً إلى هذه الانتهاكات على مرّ السنين..”.
وقد خصّ النظام السوري منذ انقلاب 16 تشرين الثاني 1970 مقومات الشعب السوري وعقيدته بالإغارة، فحاول عن طريق سياسة القمع وتفعيل قانون الطوارئ والقهر، صياغة المجتمع السوري صياغة مخالفة لدين الشعب وعقيدته وتوجهاته ومقوّمات وجوده. وفيما يلي شرح لتفاصيل مسيرة النظام بهذا الاتجاه:
3- بلا مشروعية:
لا تستطيع العصابة الحاكمة في سورية أن تستتر خلف أية مشروعية تدعم موقفها ووجودها، بل واستمرارها في الحكم، فلا المشروعية الثورية المدعاة تسعفها في ذلك، ولا المشروعية الدستورية القانونية تعطيها مسوغاً تقف فيه على أرض صلبة، من دستور أو قانون أو مشروعية ثورية.
لقد جاء النظام على ظهر طائرة حوّمت فوق معرض دمشق الدولي، حيث كان رفاق حافظ الأسد في دورة قومية لحزب البعث، ثم جاءت الدبابات وأغلقت بوابه المعرض، واعتقلت كل الرفاق؛ رفاق السلاح ورفاق الحزب المجتمعين، الذين خذلوه في انتخابات قيادات وكوادر الحزب داخل قاعة الاجتماعات، وأخرجوه خالي الوفاض من كعكة السلطة والحزب، فكان ردّه بأن انقضّ عليهم بما وقع تحت يده من طائرات ودبابات، وزجّ جميع المجتمعين أو المتآمرين -كما أسماهم يومذاك- في السجون، وطلب من الجميع تأييد انقلابه ببرقيات مكتوبة، وإلا فالمصير معروف، وقد فعل الكثيرون ذلك، ولكن الكثيرين أيضاً ظلوا مصرّين على مواقفهم في رفض تأييد انقلابه، الذي أودى بالجميع إلى المعتقلات حتى فارق بعضهم الحياة مثل رفيق انقلاب الأسد (شباط 1966) صلاح جديد الذي خرج من السجن إلى القبر، بعد احتجاز دام ربع قرن، ومثل نور الدين الأتاسي الرئيس السوري شكلاً، الذي خرج من السجن بعد أكثر من 20 عاماً، وتوفي بعد خروجه بأسابيع معدودة، وغيرهم كثيرين.
وقد حاول النظام بعد ذلك إضفاء شيء من الديكورية الشرعية على وجوده، من خلال استفتاء لم يشارك فيه من الشعب أكثر من 4% من مجموعه، حسب إحصاءات أكثر وكالات الأنباء تفاؤلاً، وذيّل النتائج -زيفاً وزوراً- بنسب تلمع بالتسعات غير المتناهية. كما حاول رموز النظام تزيين أوضاعهم بشيء من الخروج للصلاة العلنية في المناسبات، أو إيراد بعض الآيات القرآنية في أحاديثهم العلنية، وذلك من أجل استمالة الشعب المتدين.. إلا أن كل ذلك لم يستطع أن ينتزع من الناس الصورة المتسلطة بالقوة والقهر فوق الرقاب، بعيداً عن اختيار الشعب ورضاه، واعتماداً على الجيش والطائفية وأجهزة القمع، التي ملأت البلاد طولاً وعرضاً بالخوف والفزع والإرهاب، في صورة وضعها ستيفان همفري في دراسة له عن الإسلام والسياسة في السعودية ومصر وسورية، بقوله: “في سورية حكومة مشكوك في شرعيتها مهما اتّبعت من سياسات ناجحة أو فاشلة..” (2) وهو نفسه الذي استنتجته اللجنة الروسية التي شكّلت برئاسة “بريماكوف” لدراسة أوضاع النظام الداخلية، وتقديم النصائح للحاكمين بشأنها، وقدّمت تقريراً للمسؤولين جاء فيه:
“إنّ القاعدة السلطوية الجوهرية التي يستند إليها الرئيس السوري هي الطائفة العلوية، التي لا تمثّل سوى 10 بالمئة من أهالي سورية” (3).
4- عزل الشعب
لقد بدأ النظام السوري منذ 16 تشرين الثاني 1970 ينفض الأيدي نهائياً من اعتماد المشاركة الشعبية العامة، حيث أخذت السلطة تتركز بأيدي جماعة حافظ الأسد، سواء كانت هذه الجماعة طائفية من الذين استطاع أسد أن يضعهم ضمن منظوره السلطوي، ليدوروا في تلك الساحة محاطين بحرس النظام من كل جانب، لا يستطيعون حراكاً، أو كانوا من المتسلّقين المنافقين.
ولقد أضاف النظام إلى الخلفية الطائفية التي جعلها تتحكم في مصير البلد العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني، أضاف مجموعة من العوامل، استعملها في حكم البلاد، جعلت الشعب بأكمله كمّاً مهملاً. ومن هذه العوامل (التي ذكرها “فان دام” في كتابه (الصراع على السلطة في سورية)) الفساد، والصعوبات الاقتصادية، والأساليب القمعية غير الديمقراطية، والممارسات الطائفية التي طغت على السطح (4).
وقد وصف هذه الحالة من عزل الشعب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، إذ قال: “إنّ البلاد لا يحكمها الشعب بأي حال، بل العلويون… فنظرياً يدير هؤلاء البلاد من خلال الحزب، ولكن عملياً يديرونها من خلال تضامنهم السرّي داخل الحزب والمؤسسات الهامة الأخرى.. فخلف الواجهة نجد أن صلة القرابة بالرئيس العلوي الأسد هي أعظم الصفات لتقلد السلطة، وذلك عن طريق الأواصر العائلية أو الطائفية أو العشائرية” (5).
ولقد سيطرت على الأسد منذ البداية فكرة الولاء له من أجل ضمان الاستمرار، ومن هنا طبّق -مبدأ- الشك في كل من هو خارج دائرة الولاء هذه. وقد بني على الولاء من جهة، والشك من جهة أخرى، ممارسات العزل الكامل للدور الشعبي السوري، ولكل الهيئات والأحزاب في سورية، إلى درجة أن الأمر وصل إلى حزب البعث نفسه، الذي تحوّل خلال الوقت على يدي النظام إلى مؤسسة بدون فاعلية، لا تمثّل إلا واجهة تنفّذ السلطة من خلالها كل إجراءات العزل والقمع والإبعاد والفردية والقوقعة على مجموعة من الموالين الطائفيين، وقلة من غير الطائفيين.
ونظراً لأن منظومة الافكار التي تبناها النظام منذ بداياته، والمتمثلة بالعلمانية، وبالجيش الموالي، والعزل الشعبي، وأصبح كل من هم خارج هذه الدائرة من الشعب ومن الأحزاب والجماعات والتنظيمات داخل دائرة الأعداء، فقد كان التصرف تجاه الأمة هو المحاصرة والتضييق والقمع والقتل والتصفية، حتى لو كان الواقع خارج تلك الدائرة من رفاق الطائفة أو الحزب أو السلاح.
ولقد كانت هذه النظرة بالذات السبب الرئيس في عزلة النظام شعبياً وخارجياً.
وبما أن الإسلام يمثّل التناقض الرئيس والصارخ لتلك المنظومة الثلاثية من الأفكار التي تبناها النظام، فقد انصبّت ممارساته القمعية والإبعادية والتصفوية أكثر ما انصبّت على كل معتنق لفكر الإسلام وحركته مجرد اعتناق أو انتظام، وبرزت تلك الممارسات في تصفية كل متدين من جهاز التعليم، في ما عرف بمجزرة التعليم، فقد جاء ذلك ضمن الخطة التي وضعها النظام لمحاربة عقيدة الشعب وعزله وإبعاده، ووافق عليها المؤتمر القطري لحزب السلطة عام 1978 في جملة مقررات كان منها:
1- إقرار التعليم المختلط.
2- التضييق على المدارس الشرعية الخاصة، وذلك باستلام إداراتها.
3- وقف تعيين خريجي كلية الشريعة مدرسين.
4- تغيير مناهج تعليم التربية الإسلامية، وحشوها بالمعلومات المؤيدة للنظام ورأسه، ومبادئ الحزب.
5- نقل وتسريح / 500/ مدرس ثانوي وابتدائي دفعة واحدة (أتبعها فيما بعد بعملية تمشيط واسعة لقطاع التعليم وإخلائه من كل المتدينين).
هذا عدا عن المراسم الاشتراعية التي أصدرها الأسد، من أجل التدخل في التعليم الجامعي، وتوجيهه الوجهة التي يريدون، مثل المرسوم 1249 تاريخ 1979/9/20، خاص بجامعة دمشق، وبموجبه سُرّح عدد من المدرسين الإسلاميين.
والمرسوم 1250، 1979/9/20، الخاص بجامعة اللاذقية، وتم فيه تسريح عدد آخر من المدرسين الإسلاميين والموظفين.
والمرسوم 1256، 1979/9/27، خاص بجامعة حلب، قضى بنقل بعض المدرسين الإسلاميين إلى وظائف وأعمال أخرى.
وفي طريقه إلى إفساد الأجيال وإيجاد الفرقة والعزلة بينها، أنشأ منظمات طلابية وشبابية، يصنع لهم معسكرات سنوية، يشترك فيها الكبار والصغار، والفتيان والفتيات، بصورة تؤدي إلى الاحتكاك والفساد والإثارة. مثل منظمة الطلائع وشبيبة الثورة. وأجبر التلاميذ على الانتساب والالتحاق بهذه المنظمات وبمعسكراتها بقوة القانون، حيث تعرض عليهم الأفلام الجنسية، وتوزّع عليهم ألبومات من الصور الجنسية الفاضحة، وكل ذلك من أجل بناء الجيل العلمي الثوري الاشتراكي..!! على حدّ تعبيرهم.
وقد أتبع النظام تلك المجزرة بمحاربة الإسلاميين في رزقهم؛ فمنع توظيف أي متدين، وحارب مظاهر التدين من حجاب وعبادات ودروس في المساجد (إذ أصبح إغلاق المساجد بعد أداء الصلوات أمراً تفرضه القرارات والقوانين)، كما وضع دستوراً جعله في البداية خالياً من أي إشارة لدين رئيس الدولة، وفصّل مواده على قدر قامة النظام الفردية والقمعية، في منح الصلاحيات الواسعة لرأس النظام. واستطاع النظام من خلال عمليات الترغيب والترهيب شق الأحزاب، وضمّ الكثير منها إلى جوقة المؤيدين والمصفقين الموالين؛ مثل حزب الاتحاد الاشتراكي العربي (يوسف جعيداني)، وحزب الوحدويين الاشتراكيين (فايز إسماعيل)، والحزب الشيوعي السوري (خالد بكداش)، والاشتراكيين العرب (عبد الغني قنوت)، والحزب الناصري ( صفوان قدسي). حيث دخل هؤلاء جميعاً في بيت الطاعة للنظام. وأمّا الذين أبوا هذه المهانة من رجال هذه الأحزاب، وهم قلة، إمّا أنهم اعتقلوا أو أبعدوا أو صفوا..
ولقد أحدث النظام لهؤلاء المنشقين عن أحزابهم، بالإضافة إلى حزب البعث، واجهة “ديكورية” أسماها “الجبهة الوطنية التقدمية” لا يظهر لها اسم إلا في المهرجانات الخطابية، التي تمجد وتؤيد وتضفي على تصرفات النظام هالة من القدسية والشرعية -بظنهم-.
وهكذا، فإنه من خلال القمع، والفردية، والطائفية، والشللية، والانقضاض على الأحزاب، وإبعاد غير الموالين، وتقريب المحاسيب، أصبح الوضع كما وصفه محامي الشهيد حسني عابو أمام محكمة أمن الدولة المعين من السلطة، إذ قال: “هناك انعدام المساواة بين المواطنين، وانعدام تكافؤ الفرص، وانعدام حرية الرأي، والتمييز بين الحزبيين وغيرهم، وكل ذلك ممّا يخالف الدستور والقانون.. أوليس من حق أي متهم أن يناهض هذه المخالفات حفاظاً على الدستور والقانون؟”. وقد كان تعيين النظام محامياً لأحد المتهمين الإسلاميين للمرة الأولى والأخيرة، إذ لم تتكرر هذه الحالة بعد ذلك.
ولم يكتف النظام بتصفية كل شيء معارض داخل سورية، بل انتقل إلى التصفيات في الخارج، فقام باغتيال كمال جنبلاط 1978، وسليم اللوزي بسبب مقال في مجلة الحوادث، عنوانه: “النظام يكذب حتى في النشرة الجوية”. والأخت الشهيدة في ألمانيا بنان الطنطاوي، وصلاح البيطار في باريس، وغيرهم، وغيرهم.
وقد وصف أحد أعضاء مجلس الشعب السوري هذه الحالة الناشئة عن ممارسات النظام بقوله:
“إن هذه الممارسات أدت في الماضي إلى عزلة الشعب السوري عنّا، وانحساره عن مسيرتنا، وهي تؤدي الدور نفسه الآن، وسوف تؤدي في المستقبل إلى ضرب وحدتنا الوطنية و تلاحمنا..” وهو ما حدث فعلاً، فقد أنجز النظام بممارساته عزل الشعب، وتهديم وحدته الوطنية، وتخريب العلاقات الإنسانية، حتى أصبح الأخ يخشى أخاه. وتراجع اقتصاد البلد تراجعاً هائلاً/ تمثل في انهيار الليرة السورية، فبعد أن كان سعر صرفها في بداية حكم أسد يساوي ثلاث ليرات سورية ونصف مقابل الدولار، أصبح سعر صرفها في الثمانينات /40/ ليرة مقابل الدولار وفي التسعينات /50/ ليرة مقابل الدولار (إعلام أسد).
وبعد أن كانت حصة الفرد من الدخل القومي في السبعينات يفوق 1500 دولار، أصبح ذلك الدخل يقل عن 800 دولار في التسعينات، حسب الإحصاءات الرسمية، والحبل على الجرار.
5- الأسباب المباشرة للمواجهة مع عصابة أسد، والبدايات المتوجهة إلى الانقضاض على حماة وعلى سورية بكاملها
شرع النظام منذ وقت مبكر في تأزيم الوضع الداخلي في سورية، للتغطية على جرائمه وانحرافاته وممارساته الداخلية والخارجية، حيث كانت الفترة التي سبقت اندلاع المواجهة بين النظام السوري والشعب، وفي مقدمته جماعة الإخوان المسلمين، في صيف عام 1979، حافلة بالإرهاصات والنذر، التي تؤكد حتمية المواجهة، والوصول بالأوضاع إلى نقطة الانفجار، وكانت مجمل السياسات التي يمارسها النظام تخدم هذا الهدف، وهو دفع الحراك الشعبي إلى ساحة المواجهة، بغرض ضربه وتصفيته وفقاً لسياسة عامة وبرنامج مرسوم ونهج ثابت، اتبع منذ وصول حزب البعث إلى السلطة، ولعل ما يؤكد هذا الكلام، ما جاء في الخطاب الذي ألقاه الأسد الأب، في المؤتمر القطري الثالث عشر للحزب، والذي عقد في دمشق في شهر تموز ( يوليو) 1980، حيث استعرض مقررات المؤتمر القطري الثامن للحزب عام 1965، والتي اعتبرت الاخوان المسلمين ظاهرة خطيرة، بل من أخطر الظواهر، ثم انتقل إلى وضع خطة لمحاربة الإخوان المسلمين والإسلام، فقال:
“فالخطة السياسية إزاء الإخوان المسلمين وأمثالهم المتدينين لا يمكن أن تكون إلا خطة استئصالية، أي خطة لا تكتفي بفضحهم ومحاربتهم سياسياً، فهذا النوع من الحرب لا يؤثر كثيراً في فعاليتهم.. يجب أن نطبّق بحقهم خطة هجومية”.
وفي خطاب له من ثكنة الشرفة في حماة، بعد أحداث عام 1964، فضح أسد نواياه تجاه المعارضين، إذ قال:
“سنصفي خصومنا جسدياً”.
وانطلاقاً من هذه السياسة بدأ النظام في ربيع عام 1979 حملة اعتقالات واسعة، استهدفت عدداً من رموز الحركة الإسلامية من الصف الأول، تحت ذريعة ملاحقة الذين يقومون بعمليات الاغتيال ضد رموز النظام، تلك العمليات التي “بدأت في سورية بعد تدخلها العسكري في لبنان عام 1976. ولم يكن واضحاً لدى النظام في البداية من هو وراء الاغتيالات، وكان يوجّه الاتهام إلى العراق، وبعد المصالحة السورية العراقية المؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) 1978، اتهم النظام مجموعات من الإسلاميين بهذه الاغتيالات، وكان لهذه الحملة دور كبير في تسريع الأحداث وتفجيرها، ثم جاءت حادثة مدرسة المدفعية، التي وقعت في السادس عشر من حزيران (يونيو) 1979 وذلك “عندما اغتيل ما لا يقل عن 32 طالباً عسكرياً، وأصيب 54 آخرون، وقيل إن معظم الضحايا كانوا من العلويين” (2). جاءت هذه الحادثة لتشكّل نقطة انعطاف حادة في علاقة الإخوان المسلمين بالنظام، وربما كانت هذه الحادثة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى المواجهة المسلحة، وذلك حين عمدت السلطة إلى اتهام الإخوان المسلمين بارتكابها، رغم أنهم نفوا علاقتهم بها بتاتاً، في بيان سياسي أصدروه بعد الإعلان عنها، إلا أن النظام أصدر بياناً أصرّ على تحميل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية الحادثة رغم “حقيقة أنّ الضابط الذي قاد مذبحة حلب كان نفسه عضواً في حزب البعث” (3)، وشرع النظام في حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، وفي هذا السياق يمكن أن نلخّص أهم الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوع المواجهة بين الإخوان وبين النظام:
1- اتهام جماعة الإخوان المسلمين بتدبير حادثة مدرسة المدفعية، التي وقعت في الكلية العسكرية في مدينة حلب وتحميلهم مسؤوليتها، بل واتهامهم بجميع عمليات الاغتيال التي وقعت خلال السنوات التي سبقت تلك الفترة، والتي استهدفت عدداً من رموز النظام وشخصياته البارزة، حيث أصدر وزير داخلية الأسد “الدباغ” بياناً في 22 حزيران (يونيو) 1979، اتهم فيه الإخوان المسلمين بالتورط في الاغتيالات. (4) وقد جاء بيان وزير داخلية النظام منسجماً في السياق مع الخطة التي رسمها النظام منذ البداية “لتصفية الخصوم جسدياً”، وتدبير الاتهامات والافتراءات جزافاً، كي يهيّئ الجو للانقضاض وتنفيذ خطته الدموية.
2- تكثيف الاعتقالات ضد كل من يشك بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المتعاطفين معها، بل لقد امتدت حملات الاعتقال إلى جميع الفئات السياسية المعارضة لسياسات النظام وتوجهاته وممارساته، حيث رافق هذه الحملات أعمال استفزازية، أريد منها إيجاد جو من الخوف والرعب في صفوف المواطنين.
3- مسارعة النظام إلى تنفيذ أحكام الإعدام بـ/15/ معتقلاً من شباب الإخوان المسلمين، جرى اعتقالهم قبل حادثة مدرسة المدفعية بحلب، وذلك بعد محاكمات صورية عقدت لهم، وصدرت أحكام الإعدام بحقهم عن محكمة عرفية شكلت لهذه الغاية برئاسة المدعو فايز النوري، بتاريخ 28/6/1979م.
إنّ تلك الحملات الإجرامية ودعمها بالحملات الإعلامية ضد الإخوان المسلمين والإسلاميين عموماً، والشعب السوري بأكمله جعلت كاتباً مثل فان دام الألماني الكبير يقول:
“وبشكل عام بدت الحملات الإعلامية للنظام التي تلت ذلك وحملة النظام لاستئصال الإخوان المسلمين فظة وحادة للغاية، حتى أنها أثارت عداوة الشق الأعظم من الشعب المخلص، بدلاً من أن تثير تعاطفهم” (5).
4- احتلال بيوت المطلوبين للسلطة، سواء اعتقل المطلوب أو لم يعتقل، حيث عمدت السلطات إلى إبقاء عدد من رجال المخابرات في بيت المعتقل أو المطلوب لعدة أيام، يقيمون فيها مع النساء والأطفال، وذلك لتحقيق عدة أهداف؛ منها اعتقال كل زائر للبيت أو متصل بصاحبه، وإشاعة الخوف والذعر في أهل المطلوبين، وممارسة الضغوط النفسية والجسمية ضدهم لإجبارهم على الاعتراف بمكان المطلوب إن كان هارباً، علاوة على قيامهم بأعمال النهب والسلب والتخريب، تحت ذريعة البحث عن أسلحة أو محظورات فكرية يخفيها المطلوب أو المعتقل، وكذلك لإرعاب المواطنين جميعاً وإرهابهم.
5- لجوء النظام إلى أسلوب أخذ الرهائن، وذلك باعتقال آباء المطلوبين أو أمهاتهم أو إخوانهم أو أخواتهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم، ولم يكتف المجرمون بمجرد اعتقال هؤلاء الرهائن، بل عمدوا إلى تعريضهم لصنوف راعبة من التعذيب، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم (تقارير منظمات حقوق الإنسان).
6- البدء بحملة تعذيب شديدة ووحشية، ضد كل من يدخل السجن، بغضّ النظر عن التهمة الموجهة إليه، وقد أدى تسريب هذه الأخبار إلى خارج السجون عمداًَ، إلى إشاعة جو من الرعب والخوف في صفوف المواطنين، وجعل الكثير من الشباب يفكر في طريقة تخلّصه من الاعتقال، مهما كلف ذلك.
7- قيام السلطات بقتل عدد من الملاحقين في أثناء المداهمات، أو في الشوارع.
وقد أشارت الصحف الغربية آنذاك إلى كل هذه المعاني، فقالت “اللوموند الدبلوماسي”:
“الاعتقالات الواسعة في سورية في صفوف الإسلاميين تشمل الأبرياء والرهائن مع أطفال ونساء وشيوخ”.(6)
وقالت صحيفة فرانكفورتر الجمانية: “مجرد ذكر اسم النظام السوري مرادف للفزع والرعب والإرهاب، ولقد كان رد فعل النظام على طروحات الإخوان المسلمين الفكرية والسياسية حملة القتل والإبادة الجماعية والاعتقالات والمطاردات، وأطبق النظام على خناق السوريين، فكانت ذروة إرهابه مجزرة تدمر، حيث راح ضحيتها 700 سجين سياسي” (7).
في هذه الأجواء الإرهابية وجد شباب حركة الإخوان المسلمين خاصة، والإسلاميون عامة، أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما أن يصفوا في السجون والمعتقلات وتحت التعذيب دون أن يدري بهم أحد، أو أن يدفعوا موجات الظلم التي وقعت عليهم وعلى الإسلاميين وعلى الشعب السوري بكامله، بالأساليب السلمية والديمقراطية (الاضرابات، المسيرات، إيصال الصوت) ولكن النظام جابه ذلك بالنار والسلاح والصدود عن الحوار، وعندئذٍ اختار الكثير منهم طريق الدفاع عن النفس ومقاومة الظلم، تلك المقاومة التي لقيت تأييداً و تعاطفاً شعبياً، مما ساهم في انتشارها وتوسعها لتمتد إلى جميع أرجاء الوطن السوري، واشترك فيها إلى جانب الإخوان والإسلاميين كثير من فئات الناس بشتى أشكال المشاركات. وأمام تعنت النظام واستمراره في سياساته القمعية، وجدت جماعة الإخوان المسلمين نفسها في ساحة المواجهة خياراً وحيداً أغلق النظام دونه كل الخيارات، وذلك بهدف إيقاف الظلم الذي وقع عليها وعلى أبنائها وعلى الشعب السوري بأكمله، وبذلك أغلق النظام أبوابه أمام جميع الدعوات المخلصة لتجنيب البلاد والعباد إراقة الدماء ورفض الحوار السياسي والوطني، واقتصارها على الباب الأمني الإرهابي في كل لقاء أو كلام أو وساطة.
ولقد لخّصت افتتاحية العدد الأول من النذير إرهاصات المواجهة مع النظام بشكل دقيق وبيِّن، نرى من الضروري اقتباسها هنا، تقول الافتتاحية:
“على أن المحنة تبلغ أشدها حين يكون الاضطهاد مركزاً على الشعب عامة وعلى الإسلاميين خاصة وعلى الدين الإسلامي بالذات: من مساجد تهدم، وعلماء يعتقلون، ومناهج تربوية تعطل، ومدارس شرعية تغلق، ومن توجيه إعلامي وتعليمي إلحادي انحلالي يُنشر، ومن تسلّط حزبي طائفي متزايد، ومن تحضير نفسي وعسكري بتهديم الجيش والقوات المسلحة وتسليم البلاد للأعداء لقمة سائغة، (الجولان) ومن إحلال للميليشيات الحزبية أو الطائفية محلّ القوات المسلحة النظامية (سرايا الدفاع، وسرايا الصراع)، ومن نهب لثروات الأمة بالرشى والابتزاز والتجارة المشبوهة والصفقات المريبة والإثراء غير المشروع، وتتمتع بذلك النهب والإثراء حفنة قليلة من الطائفيين والمنافقين، على حساب الأكثرية المسحوقة”(8).
6- إشاعة جو إرهابي بين صفوف المواطنين
جريدة فرانكفورتر الجمانية 25/7/1981م تقول: “مجرد ذكر اسم النظام السوري مرادف للفزع والرعب والإرهاب، ولقد كان رد الفعل النظام على طروحات الإخوان المسلمين الفكرية والسياسية حملة القتل والإبادة الجماعية والاعتقالات والمصادرات، وأطبق النظام على خناق السوريين فكان ذروة إرهابه مجزرة تدمر…”.
لا شك أن شيوع موجات الاعتقال وما يرافقها وما ينتج عنها، قد ولّدت أجواء إرهابية لا تطاق في الشارع السوري.
فالبيت الذي يطلبون فيه شخصاً، يداهم وكأنه جبهة عسكرية محصنة، فالمسلحون يملؤون الأسطحة المجاورة، والسيارات المدججة بأنواع الأسلحة تملأ الشوارع المحاذية لذلك البيت تترك انطباعات غاية في السوء في نفوس الناس، وترعب الأطفال والنساء وتذل الرجال.. وكلها كانت فتائل تشتعل شاء الناس أم أبوا، وذلك الاشتعال يبعثه في النفوس القهر وتعمد الإذلال الذي لا تطيقه مروءة الرجال..
فأثناء (الاقتحام)!! تنتهك حرمات البيوت، إذ يدخل المسلحون أركان البيت بفظاظة تستفز الحجر، دون مراعاة لغرفة نوم أو ستر امرأة، ويتم ذلك أمام الرجل وعلى مرأى من الشباب الذي تتلظى في عروقه الدماء، وهو يشاهد هذه المناظر كلها وهو مجرد من كل حول وكل قوة.. والويل له إذا تلفظ بكلمة استنكار أو أبدى حركة تدل على ذلك، فإنه -ساعتئذٍ- يتحوّل إلى كرةٍ بين أرجل عناصر إرهاب العصابة الحاكمة، أمام أمه وأخته وأبيه وأهل حيّه.. هذا إن لم يقتلوه.
أمّا بعد الاعتقال، فإن الذي يقع بين أيديهم يصبح عبرة في بلده وبيئته، إذ لا مصير له سوى محطتين.. الموت تحت التعذيب، أو التحول إلى عبء على أهله وذويه، بعد أن يخرج معطوباً غير قادر على عمل أو عطاء..
فأي إنسان بعد رؤيته أو سماعه لهذه الصور الراعبة -التي لم يستثن منها أي بلد أو قرية في طول سورية وعرضها- يجرؤ على تسليم نفسه لمثل هذا المصير.. وأي طريق أبقوا له، سوى طريق المواجهة وتفضيل الموت مرات، قبل أن تصل إليه أيدي أجهزه الأمن وألوان العذاب التي تحمله وتخبئه وتستبيح به تلك العصابات حياة المواطن وكرامته بحقد غريب؟!
إن هذه الأجواء لم تكن عابرة، ولم تقتصر على يوم أو أسبوع أو أشهر، بل إنها امتدت لأربعة عقود وأكثر، والناس تعيش في رعب قاتل، والأعصاب مشدودة بقوة وألم وخوف شديد.. فكل مدينة معرضة في كلّ لحظة أن تنقض عليها عصابة الإرهاب المتسلطة أو على بيت من بيوتها أو شارع من شوارعها، يرهبونها بسيارات المخابرات والمسلحين الذين يتصفون بقسوة وفظاظة غير مسبوقة، وكأنهم يهاجمون أعداءً أزليّين لهم، في أعناقهم ثارات قديمة وجراحات عميقة ودماء غزيرة.
ذلك كله -وكثير من أشباهه- مهّد البلد للمواجهة مع النظام، خياراً لا خيار آخر غيره مهما كانت مرارته؛ فقد غيّب الزبانية عنه كل بديل. وحُجب عن رفضه كلّ مسؤول في صفوف المعارضه يؤزه ويوجهه في ذلك ما يعتلج في الصدور ويتلظى في القلوب، خصوصاً أن كل المقدّمين من إخوانهم والمَراجِعَ لصفوف قواعدهم، كانوا بين معتقل أو مشرّد أو قتيل..
فلم يُبق المجرمون لعامة الشباب سبيلاً سوى سبيل المواجهة؟!
7- في مجال الإعلام
لقد ساهم الإعلام المؤمم في سورية في صنع المواجهة ورفع وتيرتها.. إذ كان في وادٍ ومشاعر الشعب السوري وعقيدته وتقاليده في وادٍ آخر مختلف كليا..
فالصحافة والإذاعة والتلفزيون كلها، وفي معظم مساحاتها المقروءة والمسموعة والمرئية، تسبّح بحمد النظام وتمجيد رئيسه، وتحدّث الناس عن مآثر الحزب وغيره من الأحزاب والثورات التي تحارب الله وتنبذ الدين وتحطّ من قدر العقيدة.. فالمثل العليا التي تقدّم للناس هي الثورات الشيوعية وغيرها.. في الوقت الذي يُسدل فيه ستار كثيف على تاريخ الأمة وأبطالها وعلمائها..
بل إنّ الحطّ من قدر التاريخ العربي والإسلامي كان لا يخفى على متابع لأجهزة الإعلام السورية، إذ تصوّره وكأنه عصور ظلام وتخلّف وانحطاط!!
أما الناحية الأخلاقية فحدّث ولا حرج.. إذ الأفلام والمسلسلات الهابطة والمناظر التي تخدش الحياء، أدخلوها عبر التلفزيون إلى كل بيت، فيشاهد تلك اللقطات السيئة، الأب والابنة والولد المراهق، والأم التي يتفلت زمان التربية الصالحة من بين يديها، بعد أن أشاعت أجهزة إعلام النظام الفاحشةَ في صفوف الناشئة.
والبلد حينئذٍ يمور بالشباب الطاهر، والجامعات تغصّ بالفتيات المؤمنات، والجميع يرى ويسمع هذه الحرب المعلنة على الأخلاق والدين والعقيدة، وليس لديه أي متنفس، ولا يملك أي منبر يسمع من خلاله رأيه أو يوصل صوته، يقول إن هذا المجتمع مجتمع مسلم يحترم الأخلاق ويوقّر الدين وينبذ الرذيلة.. فالأولى بأي حكومة صالحة وأجهزة إعلامها -التي يُصرف عليها من عرق الشعب وكدّه ولقمة عيشه- أن تنحاز إلى صف هذا الشعب وتقيم وزناً لمشاعره بدل هذه الممارسات الممنهجة للاعتداء الصاروخ على كل مبادئه، تلك الممارسة التي تقترفها عصابة الأسد.
وكان مرجل الشعب يحتقن والحرارة فيه بارتفاع مضطرد، وقد سدّ النظام -آنئذٍ- جميع المنافذ وألغى كل سبل الاستماع لرأي الشعب، ممّا يدل بوضوح إلى أنه يتعّمد هذه الممارسات، ولم يُقدم عليها عن جهل بآثارها أو سهوٍ عن مضاعفاتها أو سوء تقدير لتداعياتها، بل هو قاصد قصداً إلى ذلك خدمة للأعداء الذين مهّدوا له التسلط على سورية.
ولما ارتفعت بعض الأصوات تستنكر ما تنضح به أجهزة الإعلام، اهتبلت أجهزة أمن النظام -المتشعبة والمتعددة والمنتظرة باستعداد كامل لأي استنكار أو انتقاد أو إبداء رأي- هذه الفرصة لتنقضّ على الشباب الذي يستقبل الحياة، ويرنو إلى المستقبل بآمال تحفّزه إلى خدمة دينه وبلده..
فكانت الجامعات والشوارع والبيوت المستورة ميداناً (عسكرياً) لأجهزة النظام، تعيث فيها وتعتقل وتضرب وتهين وتسيء.. فلم تترك مجالاً لهذا الشباب – الذي يرى من يذهبون لا يعودون، أو أنهم يعودون بعاهة دائمة تقعدهم عالة على ذويهم إلا أن يعتصم برفض الاعتقال، مهما كان الثمن الذي سيدفعه، ويراه ضئيلاً أمام الصور التي تنتصب أمام عينيه، لإخوة له سبقت إليهم يد هذه الأجهزة الراعبة.
8- احتكار الجيش ودوائر الأمن
فمن المسلّم به لدى جميع الشعوب المتحضرة أن الجيش مؤسسة لحماية البلد والذود عن حياضه.. ويُفترض فيه أن يبتعد عن المعادلات السياسية أو التحول إلى أداة قمع في يد أية مجموعة أو فئة أو حزب.
إلا أن الأيدي الماكرة امتدت إلى مؤسسة الجيش في سورية، فحرفتها عن حياديتها، وشيئاً فشيئاً استمرأ ضباط الجيش مكاسب الحكم وما تفيض من رفاهية وحياة بذخ وإسراف؛ مما جعل الجيش ينزلق في مسالك شديدة الانحدار، فترك مهمته الأساسية في حماية الوطن ومواجهة الخطر الصهيوني الذي يقف على مرمى حجر من الفيحاء. وهكذا، مال المهيمنون على الجيش إلى الصفقات والسمسرة واحتكار التجارة وغيرها. كما أنه تحول في الوقت نفسه إلى أداة قمع وسيف مسلط على رأس الشعب، فأصابه (الجيش) ما أصاب جميع المؤسسات في البلد من التمجيد بالنظام وبرئيسه، وشيئاً فشيئاً تحوّلت صورته إلى مجرد حامٍ للنظام، وهي الصورة التي تكونت في أذهان الشعب السوري عامة، والتيارات السياسية في البلد بصورة خاصة.
ولعل من المفارقات المؤلمة أن ميثاق ما يسمى الجبهة الوطنية التقدمية، ينصّ صراحة على أن دخول الجيش محظور على الفئات السياسية كافة، ما عدا حزب البعث الحاكم، الذي دخل في دوامة الفردية، ولم يعد يرى من مبادئه وأهدافه سوى المحافظة على النظام ورئيسه بأي ثمن، حتى وإن كان قد مسح شخصية الحزب وأذابها، وأهدافه في شخصية الرئيس!! يقول دكتور نيكولاس فان دام في كتابه (الصراع على السلطة في سورية): “ويبدو أن السنّيين عانوا من التمييز لدى تقدمهم للالتحاق بالكلية العسكرية ومراكز التدريب الأخرى” وقال في مكان آخر: “تبقى المراكز الحساسة استراتيجياً وسياسياً داخل القوات المسلحة وأجهزة الأمن وغيرها من مؤسسات السلطة مقصورة على أبناء الطائفة العلوية”.
فإذا أضفنا إلى ما تقدّم كله، فرض تربية وثقافة علمانية، بعيدة كل البعد عن عقيدة الشعب ودينه وأخلاقه، تبينت لنا الصورة الراعبة التي أوصلوا إليها الجيش السوري، الذي هو ابتداءً جزء من الشعب وعضو من أعضاء المجتمع بتخريبه على تلك الصورة الآنفة -بتدبير وتنسيق وإعداد مسبق وهادف للوصول به إلى هذه النتيجة- ومن ثم أصيب المجتمع السوري بكامله بعطب عميق، جرّ سورية وشعبها، مع بقية العوامل الأخرى، إلى المواجهة وتفجير الأوضاع على الصورة التي كانت..
ولا يفوتنا أن نذكّر بأن دوائر الأمن وأجهزة المخابرات كافة، قد فعلوا في المجتمع مثلما فعلوا في الجيش، بل وأشد، إذ اقتصرت على الموالين، وصُبغت بالفئوية بصورة كاملة وشُكّلت بصورة شديدة البعد عن كل قيم وأعراف ومبادئ الشعب السوري، وكأنها صُنعت في بلد علماني ملحد لا صلة له بدين ولا علاقة له بخلق ولا قيم.
في هذه الأجواء الخانقة غير المحتملة، صنعوا للبلد الهزائم العسكرية الماحقة، كما حصل في عام 1967 وعام 1973م.. وفرضوا على سورية عزلة عن محيطها العربي، لم تشهد له مثيلاً في تاريخها، حتى شعر المواطن السوري وكأنه في سجن كبير، يتعمد السجانون فيه تعميق غربة المواطن عن بلده وأمته.. وتمريغه بالإذلال داخلياً وخارجياً: داخلياً عبر أجهزة الأمن التي لم ترعَ لكبيرٍ أو وجيه أو مقدّم في بيئته احتراماً وتقديراً، بل طالته وعامة المحيطين به أو اللائذين بمكانته وجاهه، بالأذى والإهانة والتطاول إلى أبعد الحدود..
أمّا خارجياً فقد جرّ الجيش السوري إلى هزائم موجعة، وترك الأرض ليهود بسيناريو يطفح بالذل والعار..
هكذا كان حال الأجواء في سورية في تلك الآونة: أجواء ذل وعزل وهزيمة معززة بملاحقة ملحاحة من أجهزة الأمن الأخطبوطية الغليظة القاسية.. فما الذي يمكن أن تمطره هذه السحب المدلهمة؟!!! إلا أن يكون الانقضاض على حماة؛ حيث قتل جيش أسد المرتد عن الجولان أربعين ألف بريء، وهدم ثلاثة أرباع المدينة، وشرّد مائة ألف من أهلها، هذا سوى المعتقلين المعذبين، وذلك ليجعلها عبرة لأية مدينة لا تخضع لخياناته، ولتكون طريقة معاملتها دليلاً لوريثه في كيفية هدم سورية البطلة بشعبها الأبي. وهكذا كانت المقدمات فادحة في إيصال الوضع إلى التضحية بمدينة عريقة من أجمل المدن السورية، هدمت وقتل وشرد أهلها، ودمر تاريخها ومعالمها “في شباط 1982م”، تمهيداً لإدخال سورية المجاهدة الرافضة بقوة للاغتصاب الصهيوني، المصرة على الاحتفاظ بالمجد والفتح الأموي المجيد. وحق لنا القول: إن مأساة حماة وسورية كلها على يدي آل الأسد، إنما هي عنوان هذا الانزلاق لأمتنا في متاهات الباطنية التي ما أوجدت أصلاً إلا لمثل هذا العدوان على أمة الإسلام، وعاصمته عند صفويي إيران وتوابعها في لبنان “حزب اللات”، وفي اليمن “حوثيون” والمتوحشون من آل أسد في سورية!!
وأخيراً، فإن السؤال المتميز يقول:
أهو غباء بوتيني، أم تدبير عالمي أوكل إليه أن يؤهل الوريث بشار مع كل تلك الجرائم والعدوان على الوطن السوري والشعب السوري المجيد، ذلك العدوان الذي اشترك في كل حيثياته مجرمو العالم من كل نوع وطيف؟
أهو غباء أم تدبير إرهابي ماكر أن يدعو بوتين لانتخابات يشارك في مهرجاناتها وترشيحها أسد المارق الغريب عن سورية وشعبها وعروبتها وقيمها؟ ما لكم كيف تحكمون!!!
وأختم البحث بمقطع من شعر معبر:
مات في القرية كلب
فاسترحنا من عواه
خلّف الملعون جرواً
فاق بالنبح أباه
هذا زمانكِ يا مهازل فافرحي
قد عُدَّ كلب الصيد في الفرسان
—————–
الهوامش:
(1)- فان دام- الصراع على السلطة في سورية، ص 141.
(2)- المصدر السابق.
(3)- صحيفة النهار اللبنانية، 25 حزيران ( يونيو) 1979.
(4)- صحيفة البعث، 23 حزيران ( يونيو) 1979.
(5)- فان دام- كتابه الصراع على السلطة في سورية، ص 141.
(6)- العدد الديبلوماسي للوموند الفرنسية، عدد أيلول ( سبتمبر) 1979.
(7)- فرانكفورتر الجمانية الألمانية، 1981/7/25.
(8)- النذير، العدد 2، 21 أيلول ( سبتمبر) 1979.